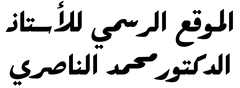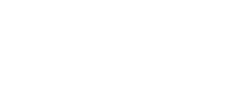لا تعسف في القول إن العلوم الإسلامية أو المعارف النقلية أو الشرعية، رغم أهميتها وتنوعها وما بذل فيها من جهد واجتهاد لم تكن كافية أو قادرة على تجلية مكنون القرآن الكريم، وعجائبه التي لا تنقضي لأمة القرآن، كما حدث في جيل التلقي على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذلك لم يتكرر نموذج جيل التلقي في أي عصر لاحق؛ بل إن الكثير من معارف هذه العلوم كانت عائقا أمام المسلمين في استنطاق آيات القرآن الكريم لاكتشاف منهج القرآن في معالجته لقضايا الإنسان والوجود والحياة. مما يمكن القول معه أن تلك العلوم والفنون والمعارف، لم توصل الأمة إلى غاياتها في القرآن وبغيتها منه. و “أنه قد حومت بالأمة حول بعض شواطئ ذلك الكتاب المجيد، الكريم، المكنون، وقدمت شيئا من الفوائد، ولكنها قد قصرت عن الإلمام “بمطلق الكتاب”، إذ هيمنت نسبية البشر على ذلك “المطلق” وقيدته إلى مدركاتها الظرفية ومحدداتها الزمانية والمكانية، وسقوفها المعرفية. فأدى ذلك كله إلى بروز تفسيرات متضاربة، وتأويلات متناقضة، وفقه مختلف، وأصول تمازجت بالفروع، وتحولت الوسائل اللغوية إلى مقاصد، بحيث صارت تتحكم أحيانا في لغة القرآن، وصارت تلك المعارف مقصودة لذاتها، أو مرجعيات بديلة يستغنى بالرجوع إليها عن الرجوع إلى القرآن إلا على سبيل الاستشهاد. واتخذت السنن النبوية بدورها معضدات وشواهد ساندات لما سبره السابرون وأصله المؤصلون لتلك المعارف والعلوم
وظن منتجو تلك العلوم والمعارف، ومدونوها، أنها باستنادها إلى القرآن الكريم، وسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، “قد صارت كافية شافية، وأنها مشتملة على معاني القرآن وبيانه النبوي، وإن لم تصرح بذلك، فحصلت قناعة خاطئة بأن الرجوع إليها رجوع إلى ما يفيده الكتاب والسنة، الذي يغني عن الرجوع المباشر إليهما، فكأن الرجوع إلى تلك المعارف، رجوع إلى مرادات القرآن المجيد وبيانه النبوي.
فأصبح تعامل هؤلاء مع هذه العلوم والمعارف باعتبارها مسلمات لا يجوز نقدها أو الطعن فيها” على الرغم من أن العلماء قديما وحديثا لم ينفكوا يراجعون الأفكار والمسلمات، حيث “ظلت العلوم الإسلامية طيلة تاريخها تخضع للمراجعة من قبل المتخصصين فيها من العلماء، وهي تلك المراجعة التي ينظر فيها اللاحق فيما أنتجه السابق فيتناوله بالتمحيص؛ يلائم بينه وبين مقتضيات ما استجد من أوضاع المسلمين، لتنتهي إلى تعديل ما ينبغي تعديله، وإضافة ما ينبغي إضافته، وربما إسقاط ما ينبغي إسقاطه، وبسبب ذلك نرى هذه العلوم تتطور باطراد في كمها وكيفها، ومهما يأتي عليها من زمن تخلد فيه إلى الركود، فإنها لا تلبث أن تنبعث فيها الحياة من جديد، وذلك بفعل هذه الفلسفة التي انبنت عليها الثقافة الإسلامية في تطور العلوم، وهي فلسفة المراجعة المستمرة من أجل التطوير والتنمية لمجابهة ابتلاءات الواقع” وهي الفلسفة التي ظلت مستمرة في تاريخ فكرنا الإسلامي؛ حتى برز في عصرنا ما سمي “نقد التراث” أو “فقه المراجعات”. ذلك أن قضايا المراجعات في تراثنا الإسلامي احتلت أهمية كبيرة في فكرنا الإسلامي المعاصر، وذلك من زوايا مختلفة فلسفية وتاريخية وسوسيولوجية… وإن اختلفت هي نفسها في منطلقاتها ومناهجها ومن ثم في النتائج المتوصل إليها (محمد عابد الجابري، طه عبد الرحمان، عبد المجيد الشرفي، هشام جعيط، حسن الترابي، أبو القاسم حاج حمد، نصر حامد أبو زيد، حسن حنفي، رضوان السيد وغيرهم…).
لا يشذ المفكر العراقي طه جابر العلواني عن هذا السياق؛ فهو أيضا على منوال هؤلاء، يتصدى للقيام بقراءات فاحصة للتراث الإسلامي، وإنجاز تشخيص دقيق لعلله وانحرافاته. واقتراح مخارج وحلول لأزماته، وقد بذل في سبيل ذلك جهدا فكريا هائلا، يسنده تكوين شرعي واطلاع غزير على التراث الإسلامي، وانفتاح على مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة، كما تشي بذلك أعماله العديدة التي خصصها لفقه المراجعات. وبخاصة كتبه: “نحو التجديد والاجتهاد: مراجعات في المنظومة المعرفية الإسلامية أولا: الفقه وأصوله”، “نحو التجديد والاجتهاد: مراجعات في المنظومة المعرفية الإسلامية ثانيا: من التعليل القرآني إلى المقاصد القرآنية العليا الحاكمة”، “لا إكراه في الدين: إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم”، “نحو موقف قرآني من المحكم والمتشابه”، “التعليم الديني بين التجديد والتجميد”.