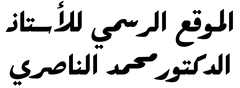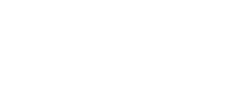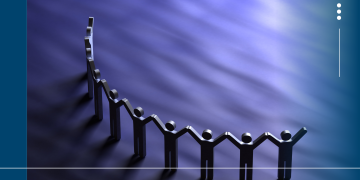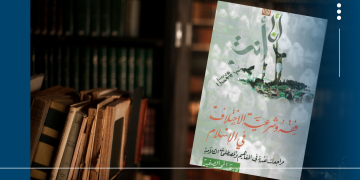إن الدراسات النظرية في عالم الغرب والعالم الآخر ليست ترفاً، كما أنها ليست عملاً مجرداً منفصلاً عن الواقع، ولكن دائماً كان التنظير، وكانت الأفكار، التي تقدم ضمن الدوائر البحثية والأكاديمية والفكرية الغربية، متصلة من قريب أو من بعيد بمجال الحركة، إذ أصبح كلّ شيء خاضعاً للدراسة والتحليل. ولعل المختبرات التي تخضع لها القضايا الفكرية والثقافية، وجميع الدراسات الإنسانية اليوم، توازي المختبرات التي تخضع لها العلوم التجريبية، إن لم تكن أكثر دقة واهتماماً، حيث لم يعُد مجال للكسالى والنيام، والمتخاذلين والأغبياء…
ففي القارة الأمريكية وحدها هناك حوالى عشرة آلاف مركز للبحوث والدراسات -القسم الكبير منها متخصّص بشؤون العالم الإسلامي- ووظيفة هذه المراكز تتبّع ورصد كل ما يجري في العالم، ومن ثم دراسته وتحليله، مقارناً بأصوله التراثية التاريخية، ومنابعه العقائدية، ثم مناقشة ذلك مع صانعي القرار لتُبنى على أساسه الخطط، وتوضع الاستراتيجيات الثقافية والسياسية، وتحدد وسائل التنفيذ.
ومن أبرز الأفكار التي خرجت من رحم تلك المراكز، نظرية هانتنغتون عن صدام الحضارات، التي بدأت محاضرة في معهد الاقتصاد الأمريكي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1992، بعنوان «صدام الحضارات»، ثم تحولت إلى مقال نشرته فصلية فورين أفيرز في عام 1993 تحت العنوان نفسه. ثم كان الكتاب بالإنكليزية الذي حمل عنوان: صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي عام 1996.
لقد كان لأطروحة «صدام الحضارات» صدى قوي، حيث فتحت منذ نشرها صيف عام 1993 سجالات ثقافية وسياسية واستراتيجية حادة في أنحاء كثيرة من العالم، وأثارت ردوداً متباينة تراوحت بين التأييد والتحفظ والرفض، حيث أورد محرر مجلة الشؤون الخارجية أن مقالة هانتنغتون قد حرّكت نقاشات تفوق ما أثاره أي مقال نُشر منذ عام 1940 حتى عام 1993.
ترى، لماذا كل هذا الاهتمام بأطروحة «صدام الحضارات»؟ ما مضمونها ومرتكزاتها؟ وما هي البراهين التي تعتمد عليها لتدعيم أسسها النظرية؟ وما موقع التكتّلات الحضارية داخل هذا الصدام الحضاري؟ وما تأثير ذلك في طبيعة وصيرورة العلاقات الدولية؟ ما هي خلفيات الأطروحة وأبعادها على المستوى الفكري والفلسفي؟ أي ما هي حمولاتها الفلسفية وطبيعة نظرتها إلى العالم، باعتبارها تجسيداً حيّاً للأفق الاستراتيجي الذي ولدته نهاية الحرب الباردة، وما هي الأهداف الاستراتيجية الموجّهة لها؟ وما هو تأثيرها في الآفاق التنظيرية للعلاقات الدولية، وفي المنطقة العربية والإسلامية على الخصوص؟
هناك أسئلة، وأخرى نظيره لها، مثلت الخلفيات العلمية والمبرّرات الواقعية التي تنهض عليها فصول كتاب: «مستقبل العلاقات الدولية: من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام» لمحمد سعدي. والكتاب ذو الأقسام الثلاثة يضمّ في شكله العام: مدخلاً، ومقدمة، وثمانية فصول، وخاتمة.
لقراءة المقال كاملا يُرجى الضغط هنا